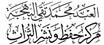وما إن بلغ هذا المولود شهره السّادس عشر حتّى اختطفت يدُ الموت أمّه الحنون التّي كانت تغدق عليه الحبّ والرّحمة، وفَجَعَ فقدُها تلك الأسرة الّتي خيّم عليها الحزن والألم، إلّا أنّ أُخته الكبيرة «معصومة خانم» قامت مقام أُمّها وتكفّلت تربيته فأصبحت أُمّاً لأخيها، تصحبه معها أينما حلّت.
في أحد الأيّام أرادت «معصومة خانم» أن تقوم برفقة عدد من نساء المدينة بزيارة أحد مراقد أبناء الأئمّة (عليهم السّلام) القريبة من مدينتها، فاصطحبت معها الطّفل «محمّد تقي» وتوجّها معاً إلى زيارة المرقد الطّاهر، وهناك حيث هدأت الأصوات وخشعت القلوب للّه الجبّار، كانت توجد حصاة بالقرب من الضّريح المبارك معروف عنها أنّها ما من زائر دعا عندها إلّا وتمّت الإجابة له بالرّد أو القبول، وتقدّم الطفل ليهمس بكلمات العشق المكنونة في صدره سائلاً:
«هل سأتشرف بزيارة كربلاء؟»
فتحرّكت الحصاة في كفّه إعلاناً بقبول الإجابة، وهذا يدلّ على المقام المعنويّ لهذا الطّفل الّذي كان يختلف كلياً عن باقي الأطفال، حيث كان بعيداً كلّ البعد عمّا يهوونه من ملذّات الدنيا الطّفوليّة، بل كان مستغرقاً في عالمه الإلهيّ الخاصّ.
وترعرع «محمّد تقي» يصطحبه والده في ذهابه وإيابه حتّى أصبح جليس أبيه ومؤنس وحدته، وهو يرى بحجمه الصّغير وروحه الكبيرة كيف يتحوّل حبّ أهل بيت النّبي الأطهار (عليهم السّلام) في قلب والده الحزين إلى منهلٍ يروّي صفحات الأوراق، لتتفجّر ميراثاً يردّده المتولّهون بحبّ الحسين (عليه السّلام)، ثمّ يتحوّل إلى تمتمات تترنّم بها شفاهُهم في مجالس العزاء الحسينيّ. حتّى إذا ما تشبّعت نفس «محمّد تقي» الصّغير بهذه التّلاوات الحسينيّة وارتوت روحه بنفحاتها النديّة، بدأ قلبه يتبرعم رويداً رويداً على حبّ شهيد العشق والمحبّة، وبقي يلتاع ألماً وحزناً بلوعات مصاب ذلك الإمام المظلوم، لما يقرب قرناً من الزّمن حتّى وُورِيَ الثّرى.
هكذا درج «محمّد تقي» من عشقه لسيّد الشهداء أبي عبد الله الحسين (عليه السّلام)، حتّى انتهى به المطاف إلى زاوية في «مكتب خانه[1] الملّا حسين الكوكبي الفومني»، وهو مكان مؤلّف من غرفة واحدة ينعقد في هدوئها محفلٌ لتعليم القرآن، حيث يجلس المُلّا ليعلّم تلامذته قواعد التّلاوة القرآنيّة، وهنا أصبح «محمّد تقي» وهو في نعومة أظفاره يتلو آيات القرآن الكريم، ليطوي هذه المرحلة من عمره بذلك الصّوت الجذّاب الّذي راح يبدّد ذلك الهدوء وهو يرتّل «الحمدلله ربّ العالمين»، لتمتلئ نفسه التوّاقة بنور الذّكر الحكيم، ويتعطّر فمه بتلفّظ السورة المباركة، إلى جانب ذلك راح هذا التّلميذ وبجديّة فائقة الوصف، وشوق متزايد يطوي السير سبع سنوات بتجوال بصره وإعمال فكره في المتون الأدبيّة الفارسيّة، ككتابي «بوستان» و«گلستان»[2] و كتاب «كليلة ودمنة» وبعض الأُمور الحسابيّة، حتّى أصبح من تلاميذ الأستاذ الأوائل.
ويتألّق النّور الإلهيّ فيبدو جليّاً على الفتى، وتظهر ملامحه للجميع، فقد استطاع أن يدرك الحالات المعنويّة والمقامات العاليّة لإمام الجماعة في مسجد منطقته «الشّيخ أحمد السعيدي» الّذي كان معروفاً بزهده وتقواه بين أهل المدينة، وكلّ ذلك بفضل نقاء فطرته وبصيرته الّتي كانت تخرق الحجب لتصل إلى معدن العظمة، حتّى صارت روحاهما تلتقيان في المسجد عند كلّ صلاة، فكأنّ الشّيخ أحمد السّعيدي هو أوّل شخصيّة قد تأثّر بها الطّفل، فراح ينهل من معينها علوماً وفيوضات إلهيّة، جعلته نجماً متألّقاً في الحكمة والرّصانة وعمق التّفكير، حيث جرت ينابيع الحكمة على لسانه، وظهرت في حركاته وسكناته، لتكون عِبَرَاً لمن ألقى السّمع وهو شهيد، وينقل في ذلك أحد المعمّرين من مدينة فومن:
إنّه في إحدى اللّيالي، وبينما كان يسير «محمّد تقي» مع صديقه في الشّارع وإذا بهما يريان حشرة مضيئة، فيقترب «محمّد تقي» منها مطلقاً عبارات الحكمة قائلاً لصديقه: «يمكن للإنسان أن يكون مصدراً للنّور، ويضيء بنوره للآخرين كما يفعل هذا الكائن الصغير المضيء!» فاستغرب صديقه من كلامه فأكمل الطّفل «محمّد تقي»:
«ليس ذلك إلّا بترك المعصية!».
وكأنّ يد الغيب تطلق على لسانه كلمات فيها من الحكمة والموعظة ما هو لأولياء الله ينابيع علم خصّهم بها، ليدلّ كلّ ذلك على مقام وعظمة هذا الطّفل عند الله.
وكذلك تميّز بعلمه وبالإحاطة الشّاملة والتّامّة بِالمسائِل الفقهيّة، حيث كانت ترجع إليه النّساء العفيفات في المسائل الشّرعيّة الخاصّة بهنّ لصغر سنّه، ولاستحيائهنّ من الرّجوع في ذلك إلى علماء المنطقة.
لكنّ روح هذا الفتى العطشى لم ترتوِ بعدُ، حيث كانت تتطلّع للمزيد من المعرفة فيمّم وجهه شطر الحوزة العلميّة في فومن، لتُفكِّك له بمعارفها أسرار آيِ الذّكر الحكيم، ورموز روايات الأئمّة الأطهار من آل محمّد صلوات الله عليهم أجمعين لِتَعيَها أُذنه الواعية. وهنا في فومن بدأ «محمّد تقي» دراسة المقدّمات الحوزويّة عند «الشّيخ القاضي المتّقي»، والّذي كان يهتمّ به لنشاطه ومثابرته واستعداده، وكان «محمّد تقي» يرسّخها بحلقات المباحثة والحوار ومذاكرة العلوم الدّينيّة المختلفة.
ولم تنته تطلّعات «محمّد تقي» عند الدّراسة الفقهيّة فحسب، بل كان يطوي بموازاة ذلك طريق المعرفة والأخلاق وتهذيب النّفس وكسب الفيوضات المعنويّة على يد «آية الله الحاج الشّيخ أحمد السّعيدي الفومني»، خاصّة تلك الأوقات الّتي كان يأتمّ فيها بهذا العالم الربانيّ وما تحمله من بهاء معنويّ وصفاء باطنيّ، بقيت آثارها في مخيّلة الإمام والمأموم[3].
ولم يكن هناك شيءٌ يمنع «محمّد تقي» عن زيارة قبر والدته «مرضيّة خانم» على الرّغم من انشغاله الدّائم والمستمرّ في تحصيل العلوم والمعارف، وبالإضافة إلى مساعدته لوالده، واستغراق وقته كلّه لكنّه كان يزور قبر أُمّه الّتي لم ترها عيناه منذ الصّغر، فَلِكَمال معرفتهِ بحقّها عليه وتمام بِرّه بها كان يوفي ذلك الحقّ بمواظبته كلّ يوم على زيارتها مرتّلاً عندها آيات من الذّكر الحكيم، إلى أن تمّ نقل القبر فيما بعد الى أرض الطّفّ بجوار الإمام الحسين (عليه السّلام).
[1] أي: «كتّاب».
[2] وهما كتابان في النّثر و النّظم باللغة الفارسيّة.
[3] لقد كان آية الله سعيدي الفومني فيما بعد يتقصّى أخبار آية الله البهجة سائلاً والده: «ما هي أخبار زميلنا؟!».