كان اليوم الثّاني والعشرون من شهر جمادى الأولى من سَنَة ١٤٣٠ هـ . ق قد أرّخ نهاية الانتظار، وأعلن الوصول إلى حدائق ذات بهجة، وتحقّق منية الوصال الأبديّ الّذي كان هذا الشّيخ العظيم ينتظره طول حياته الطّيبة الّتي جاوزت التّسعين.
انتظارٌ سطّر به الشّيخ أجمل معاني العشق الإلهي، وروى به روايةً قد ألّف صفحاتها من آيات ومناجاة، رواية العبوديّة لربّ السّماء.
لقد كان انتظار المقدّس الرّاحل لهذا العروج بكامل وجوده، بجسمه الذّابل النّحيف، وروحه الظمأى المكابدة، حتّى حانت لحظة الرجوع إلى الله ...
ينقل نجل سماحته الشّيخ علي حول حالات والده قبل الوفاة:
«إنّ سماحته قبل وفاته بأسبوع، كان يتحدّث حول الموت كثيراً، قبل الوفاة ببضعة أيام، (يوم الأربعاء أو الخميس قبل ذلك)، فإنّ والدي وفي أثناء خروجه من المنزل قال لوالدتي: أتسمعين؟
قالت: نعم!
فقال: هل تعرفين الشّخص الفلاني في فومن؟
فقالت: نعم!
فقال سماحته: هو كان يقول هذا الشعر:[1]
ياران وبرادران، مرا ياد كنيد رفتم سفري كه آمدن نيست مرا
وتابع قائلاً: هل سمعتي؟
فأجابت والدتي: نعم!
وتبسم والدي وهذا، كان آخر كلام قاله لأمّي ...
طبعاً ذاك الوقت ولأنّي لم أعرف سبب قراءة بيت الشّعر هذا، لم يكن مفهوماً لدي.
وفي صباح يوم السبت ٢١/جُمادى الأولى/١٤٣٠ هـ . ق السّاعة التّاسعة والنّصف ذهبت لحجرة والدي فما رأيت سماحته ، اتّصلت فقالوا: مضت عشر دقائق وهو جالس أمام الباب، ركضت حافياً، وذهبت لسماحته، رأيته جالساً وبهيبة عالية وظهره مستقيم ولم يكن متأثّراً بانحناء ظهره الّذي كان لديه، وكأنّه رجع عشر سنوات إلى الوراء، وصار أكثر شباباً.
قلت: شيخنا! لماذا أتيت إلى هنا وجلست؟
رفع رأسه وقال: بلى؟
دائماً عندما يكون في الذّكر أو يغرق في التّفكير كان يحتاج للحظات حتّى يخرج من تلك الحالة.
قلت: شيخنا! ما زال هناك أكثر من نصف ساعة لوقت الدّرس لماذا أتيتم جلستم هنا؟
فقال: الآن قد جلست!
فذهبت وانشغلت بأعمالي، ولكن بعد عشر دقائق، اتّصلوا بي من أمام الباب وقالوا إنّ سماحته يقول:
«أخبروا أنّه لن أذهب إلى الدّرس ولا إلى الصّلاة في المسجد»، وجلس في نفس المكان.
ركضت بسرعة وأوصلت نفسي إليه. فقال سماحته: «لقد آلمني بطني دفعةً واحدة، أخذت كأساً من الماء شربته لكن لم يذهب ألمي، لا طاقة لديّ».
نقلت سماحته إلى حجرته للاستراحة، استمرّ ألم بطن سماحته إلى صباح اليوم التّالي، فقلت: هل أحضر الطّبيب؟
فقال: لا.
فقلت: هل ألمكم شديد؟
فقال: ليس شديداً جدّاً.
صباح الأحد ٢٢/ جُمادى الأولى/ ١٤٣٠ رأيت أنّ سماحته قد صلّى صلاة الصّبح من جلوس، فتعجّبت، لم يكن لديه سابقة بأن يؤلمه بطنه لهذا الحدّ الّذي يوجب ضعفه بحيث لا يتمكّن من الوضوء ويصلّي متيمّماً من جلوس.
بعد عشرين دقيقة من الصّلاة، كانت زوجتي قد جاءت، ولأنّها كانت تتصوّر أن سماحته لم يكن قد صلّى، فسألت بتعجّب: سماحته فقط يقول: السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته!
أنا كنت قد سمعت سلام سماحته مرّتين ومع هذه المرّة أصبح ثلاث مرات، فقلت ربّما قد شكّ في الصّلاة ويكرّر هذه الجملة.
فقالت: لقد تمدّد سماحته.
فقلت: لا مانع، لأني قد رأيته صلّى مرتين، بالطّبع لا أعرف ما قبله.
بعد ذهاب زوجتي، رأيت سماحته قال مجدّداً: السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكرّر هذه الجملة سبع أو ثماني مرّات، فتعجّبت من فعل سماحته.
قبل الظّهر حين أتت زوجتي أرادت أن تحرّك له المروحة اليدويّة. فقال سماحته: «لا، أعطني أنا أحرّك المروحة بنفسي».
رأيت أنّه نظر إليّ نظرة ذات مغزى، وبعدها إلتفت إلى زوجتي ولم يرفع نظره عنها. بعد مدّة قال لها: «الآن إذا لم يكن هناك زحمة، هيّئوا لي كأس عصير التّفاح، ربما أشربه[2]. حيث إن سماحته كان كثيراً ما يستعمل عصير التّفاح للعلاج.
فرحت هي وذهبت، بعد لحظات، جاء ابني. فقال له: «اذهب وصلِّ» فأجابه: لم يؤذّن بعد، فقال سماحته: الآن اذهب وتوضّأ.
بالنّهاية أرسل الجميع خارجاً ولم يترك أحداً يبقى معه.
اتصلت بالطّبيب، وطلبت منه أن يأتي إلى المنزل ليعاين سماحته فقال: آتي بعد السّاعة الثّانية عشر حين ينتهي عملي.
في السّاعة الثانية عشرة والنصف جاء الطّبيب، فقلت لسماحته: هذا الطّبيب، وذكرت له اسم الطّبيب. فقال سماحته: حفيد سيّد الذّاكرين؟
فقال الطّبيب: شيخنا! أنا قلت لسماحتكم عن شجرة نسبي قبل خمس سنوات، أتذكرون ذلك إلى الآن؟
فقال سماحته: نعم. أذكر أنّي قلت لكم أيضاً اتركوا لحيتكم قليلاً حتّى تصلوا لمقامات جدّكم. لقد رأيته [أي جدّكم] رحمه الله.
فقلت لوالدي: سيدي! لقد ترك شيئاً من لحيته. فقال: ليترك أكثر من ذلك بقليل.
فسماحته كان يقول هذا الكلام لكلّ شخص يحلق لحيته.
قاس الطّبيب ضغط دم سماحته، إحدى يديه كانت سبعاً والأخرى كانت إحدى عشرة. ومهما حاول لم يكن ليعرف مرض سماحته، فقال في النّهاية: يحتمل أنّه حصل معه تمزّق أمعاء.
اتّصلنا بطهران حتّى يهيّئوا المستشفى، وسماحته أصرّ أن ننزله عن السّرير حيث قال: «لست مرتاحاً على السّرير».
عندما أنزلت سماحته من فوق السّرير قال لمرّة واحدة: الحمد لله. ووضع رأسه على ذراعه.
فقلت: سيدي، هل أحضر لكم وسادة؟
فقال: لا، لا أريد!
فقلت في نفسي: إنّ سماحته بطنه آلمه اللّيلة الماضية ولم ينم، والآن لأنهم أعطوه مسكّناً، جيدٌ أن يستريح.
كنت متوتّراً. هيّأت الملابس والملف الطبّي وماء زمزم وتربة كربلاء حتّى إذا كان هناك حاجة للعمليّة الجراحيّة، تكون هذه الأمور معي، قلت أيضاً ليهيّئُوا السيّارة.
كانت السّاعة ما بعد الواحدة ظهراً، وعندما أردت أن أهيّئ سماحته لأنقله إلى طهران، أصبحت الريّاح قويّة جدّاً، صوت الرّعد والبرق القويّ والأصوات الموحشة في ذاك الجو كانت ترنّ في الأذن، وهطل مطر غزير.
كنت أفكّر مع نفسي: إلهي كيف أنقل سماحته إلى طهران مع حال الجوّ هذا!
بالنّهاية هدأت الرّيح، وكانت السّيارة مجهّزة، ذهبت لأوقظ سماحته، لكن مهما فعلت لم يكن سماحته يستيقظ!
فقال الآخرون: هل نخبر الإسعاف؟
قلت: لا! ذُهِلْتُ، لم أكن أصدّق أنّ سماحته قد فارق الدّنيا. كنت أحتمل أنّ سماحته في حالة شبيهة بالموت الاختياريّ. جسمه كان حارّاً أيضاً ...
طبعاً اتصلوا بالإسعاف وأتوا، ولكن مهما سعوا لم يتمكنوا من فعل شيء، وقالوا يجب نقل سماحته إلى المستشفى، ولكن أيضاً هناك لم يتمكنوا من فعل شيء.
تبيّن أن والدي قد تعمّد إخراج الجميع من الحجرة، ولم يكن أحدٌ عند سماحته في الحجرة ساعة وفاته، حتّى لا يتعرّف على حالته حينها».
أجل ففي حوالي السّاعة ١٤:٤٠ من ظهر يوم الأحد كان الطّقس هادئاً وجميلاً، لكن فجأةّ تلبّدت الغيوم السُّوْد، وكأنّها ارتدت ثياب العزاء، وأمطرت السّماء بغزارة كأنّها كانت دموع الألم والفراق، أمّا دوي الرّعد فكان قويّاً، كأنّه صيحات أسىً وعزاء، وكأنّ السّماء تنعى رحيل العبد الصّالح الشّيخ محمّد تقي البهجة، وعروجه إلى الملكوت الأعلى ...
ونُعيَت الرّوح الطّاهرة إلينا فاهتزت أفلاك دنيانا حزناً وافتجاعاً، ارتدينا حلّة الأرزاء والألم، غرفنا غرفة الحزن من بئر الأحزان، وتاهت أرواحنا باحثةً عن روح ملائكية كانت بيننا، ننعم بسكونها، نُسقى من معينها، نُرَوِّي أعين وجداننا بالنّظر إلى بريقها، لبسنا سربال الأسى آخر لحظات الوداع لروح الشّيخ، عفّرنا وجوهنا بثرى الافتجاع، وألبسنا عيوننا ثوب العزاء، من دموع حرّى وقطرات حنين، وغابت شمس ذاك النهار،إلّا أنّ بدر السّماء لم يسبح في كبدها كعادته، أتُراه ارتحل؟!
فكان هذا اللّقاء أجر تعب ونصب ومشقّة العقود التّسعة الّتي تصرّمت بالسّعي الحثيث والمجاهدة لاجتياز عقبات السّير إلى المحبوب، فغدى تضمّه يد الأمان والرّاحة والرّحمة الرّحمانيّة. لكن هذا الهناء والأمان لذلك الواصل، صار عزاءً وانكساراً دائمين وصدمة لا يتحمّلها سيل المشتاقين الّذين كانت رؤيته تذكّرهم بالله.
فلقد كان غروب يوم الأحد غروباً كدّر مدينة قم بحُللِ الغصّة والأسى فما أن شاع خبر الوفاة على الأفواه حتّى تملّك البلدةَ الذّهولُ والحَيْرةُ، وسرعان ما تحوّل الأمر إلى أنّةٍ ورنّةٍ وتوجّعٍ ونياحٍ وعويل.
وتناقلت المحافل الخبريّة النبأ الّذي صدّع القلوب وهُرِعَ سيل الوالهين من أبناء المرجعيّة نحو قم الّتي توشّحت بسواد الحزن وكان تشييعه تشييعاً منقطع النّظير، أمّا السيّدة المعصومة عليها السلام، فقد همّت روحها مستقبلةً روحَه التّائقة لجوارها، مستضيفة الجسد الطّاهر في حرمها المطهّر، وكأنّ ابنة موسى بن جعفر عليهما السلام قامت بواجب العزاء والاستضافة لجسد عارفٍ أبت إلّا أن يُدفن بالقرب منها، فتسعدَ روحُه بقربها، وتأنس نفسه بعظمتها، وأخيراً ووُريَ الجثمان الطّاهر للعارف الواصل في حرم السيّدة فاطمة المعصومة عليها السلام بنت الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام في البقعة الأقرب لضريحها عليها السلام.
وأمّا في مسجد الفاطميّة فقد حلّ السّكوت وخيّم الحزن والوُجُوْمُ وعمّت آهات الفراق، فراق تلك القلوب الوالهة المفجوعة لذلك الأب الكبير الّذي كان يطّلع عليها من بين نوافذ ذلك الباب الخشبيّ الصّغير المجاور للمحراب وهو مطأطئ الرّأس، عَطِر الشفاه بالذّكر، مغرورق العينين بالدّموع، قد نوّر السّجود جبهته الغرّاء.
وفي غمرة هذه الوحشة الّتي لَفّت المسجد، ما عليك إلا أن تيمّم قلبك نحو حرم كريمة أهل البيت عليها السلام، لتقف وتقدّم الهديّة لروحه الطاهرة بتلاوة باقة من آيات القرآن لتنال منه الهديّة، إذ إنّ هذا هو دأب العلماء الرّبانيّين في ردّ الجميل بالأجمل، كما يقول سماحته : إنّ العلماء لا يحتاجون لأن نقرأ الفاتحة لهم، لأنّهم قد أدّوا الّذي عليهم، لكن نحن من نحتاج إلى زيارتهم.
وما عليك إلّا أن تصغي بقلبك إلى تراتيل «يس والقرآن الحكيم» الّتي أصبحت في ليلة الجمعة تعرج إلى العرش من جوار ذلك المضجع الطاهر بدلاً من عروجها من مسجد الفاطمية صبيحة يوم الجمعة ...
تغيّبت شمس تبوّأت القلوب منازل بدلاً عن الأفلاك، فوهت قواعد الصبر وانحنى الظهر، وفيض المدامع غمر، نبكي بدرنا الّذي ضمه القبر، والحزن لفقده يهيجه الذّكر. ليته يعود كي نستفيق من سكرتنا على وقع العزاء، ولكن أنّى ذلك و قد حضنته السّماء؟! فجديرٌ بنا أن نظلّ على نهجه سالكين و على ذكره عاكفين، فإنه أسوة العارفين و قدوة العالمين و بهجة الميامين ...
[1] معنى بيت الشعر: أيها الأصدقاء و الإخوان اذكروني، ذاهب إلى سفر ما منه رجوع.
[2] ينقل نجل سماحة الشّيخ: «بعد أن علمت زوجتي برحيل سماحة الشّيخ قالت: أحسست أنّ سماحته كان يودّعني بنظرته الطّويلة إليّ، لم أتحمّل كاد قلبي أن يتوقّف حيث إن سماحته طلب منّي عصير التّفاح، هنا فرحت و حسبت أنّني قد اشتبهت!».
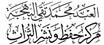

76 Replies on بلوغ المنى ...
التعليقات مغلقة.