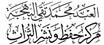فقد ابتهجت نفسه بشمِّ ترابها المقدّس، وتنفّست روحه عبير ذلك الضّريح الملكوتيّ، فوقع يلثم أعتاب سيّد الشّهداء الإمام الحسين (عليه السّلام). ولم يكن المهاجر يومها قد بلغ الحلم حيث كان في ربيعه الرّابع عشر[1]، لكنّه كان يحمل كنوزاً من العلم والمعرفة. ففي الزّيارة الأولى لمقام سيّد الشّهداء (عليه السّلام)، جمع الله تعالى بين العالم الأُصوليّ الكبير «الميرزا النّائيني(قدّس سرّه)» وبين اليافع الموالي «محمّد تقي» في أوّل صلاة جماعةٍ، وفي أول زيارة لهذا اليافع لمقام سيّد الشّهداء (عليه السّلام). فكانت هذه من المنح الحسينيّة الّتي أُفيضت على قلب الغلام الموالي «محمّد تقي»، أن جمعه الله مع العالم التّقي النّائيني، وأراه من حالاته المعنويّة[2] ما جعل قلبه بعطاء ربّه رضيّاً. وهذا الأمر إنّما حصل بتدبير إلهيّ، ولم يكن هذا اللّقاء عابراً، وإنّما هي من الأمور الّتي يعدّها الله تعالى لأوليائه، تمهيداً لصناعتهم لخدمة هذا الدّين الحنيف، فكان هذا اللّقاء الجامع بين اليافع الربانيّ والعالم الربانيّ هديّة حسينيّة ممهّدة لكي يصبح «محمّد تقي» من تلامذة العلاّمة النّائيني عندما ذهب فيما بعد إلى النّجف الأشرف.
أقام «محمّد تقي» بادئ أمره في بيت عمّه الّذي كان يومها يسكن كربلاء المقدّسة وبقي فيه لمدّة سنة، حيث لم يستنكف يوماً عن خدمته أو يتململ من وجوده، وكان يؤمّن له كلّ حاجاته، ولا يجعله يحتاج أن يطلب منه شيئاً، فهذا الضّيف الربانيّ هو هديّة الله تعالى إليه، فكان يتعامل معه كنعمةٍ منّ الله تعالى عليه بها، فيتفانى في خدمته، ويتولّى بنفسه الإهتمام بأموره وشؤونه، ثمّ انتقل إلى حجرة في المدرسة البادكوبيّة العلميّة.
ولله درّه أيّ دقّة لا متناهية في تطبيق حدود الله تعالى كانت عند الفتى «محمّد تقي»، والّتي جعلته مراعياً لحدود شريعة ربّه إلى هذا الحدّ، لقد قرّر الفتى الّذي بلغ سنّ التّكليف وبلغ من عمره خمس عشرة سنة أن يترك بيت عمّه، فالميرزا علي الأكبر كان يرعاه بأشفار العين، ويؤمّن له المأكل والفراش لينام قرير العين، ويرافقه قبل بزوغ الفجر لزيارة الإمام الحسين (عليه السّلام).
فعمّه كان تقيّاً، كما كان قلبه بابن أخيه مسروراً رضيّاً، فما الّذي جعل قرّة عينه يبتعد عن عينه؟ ولكن قلبه ازداد لهذا الغلام حبّاً، عندما أدرك أنّ في رحيله من بيته، لله تعالى فيه سببٌ، حيث إنّ الفتى الزّكيّ «محمّد تقي» رفض أن يبقى في منزل عمّه الحبيب، لأنّه بلغ سنّ التّكليف، ولم يسمح لنفسه في المبيت في دار عمّه على الأقل لوجود زوجة عمّه في الدّار. فكان الفتى «محمّد تقي» منذ صغر سنّه من أهل المراقبة، أي أنّه كان لا يدخل في مواطن الشّبهة فضلاً عن ابتعاده عن المعصية. ولم يكن ليسهو يوماً عن الحضور والزّيارة لمقام سيّد الشّهداء (عليه السّلام) وأخيه أبي الفضل العبّاس (عليه السّلام)، كما كانت بعض مباحثاته يحضرها بجوار ضريح سيّد الشّهداء (عليه السّلام)، فكان هذا دأب الفتى «محمّد تقي» منذ أوّل نشوئه في المواظبة على زيارة المعصومين (عليهم السّلام) بشكل يوميّ ومنظّم ليبقى ناهلاً من فيض نميرهم الإلهيّ الّذي لايمكن نيله إلا من خلال إخلاص المحبّة والمودّة لهم، وهذا ديدن أولياء الله، وقد كان مكبّاً على العبادة ومقبلاً عليها بكل وجوده قبل التّكليف وكان يهتمّ بالصّلوات المستحبّة فضلاً عن الصّلاة الواجبة، وينقل أحد المطّلعين على أحواله في تلك الفترة أنّه في إحدى المرّات الّتي ذهب فيها لزيارة مسجد السّهلة، كان قد صلّى ركعتين مندوبتين فقرأ في الرّكعة الأولى سورة البقرة وفي الثّانية سورة آل عمران عن ظهر قلب، وهذا يدلّ أنّه كان مهتمّاً بحفظ القرآن وكذلك يدلّ على اهتمامه الشّديد ورغبته الحثيثة بالعبادة لا سيما الصّلاة منذ نعومة أظفاره.
كانت الحوزة العلمية في كربلاء آنذاك تزهو بوجود أساتذة كبار ممّا جعل «محمّد تقي» يشمّر عن ساعد الهمّة ويطوي مراحل مهمّة في دراسة الفقه والأُصول خلال سنوات إقامته الأربع فيها، وفي السّنة الثّانية من إقامته ولدى مجيء والده الرؤوف إلى كربلاء المقدّسة جرت مراسم تتويجه العمامة على يد «آية الله الشّيخ جعفر الحائري الفومني (قدّس سرّه)» الّذي كان قد درس على يديه اللّمعتين[3]، كما قد درس على يد كبار علماء كربلاء في وقتها كـ«آية الله الشّيخ أبو القاسم الخوئي الحائريّ(قدّس سرّه)». وقد واكبت نشاطه الحوزويّ في هذه المُدّة، جهوداً جادّة في مسار تهذيب النّفس وتحصيل معالي الأخلاق من خلال تضرّعه وتوسّله بسيّد الشّهداء (عليه السّلام)، الّذي كان يقضي أوقاتاً معنويّة سامية بجوار حرمه، منحته مرتبة أعظم من المراتب العلميّة الّتي نالها.
وأمّا من الناحيّة العلميّة فكان «محمّد تقي» جادّاً في التّحصيل مكبّاً على الدّراسة بكل ما أُوتي من معنويّات ولم يكن ليكتفي بالكتب الدّراسيّة وإنّما يقرأ معها كتب المراجع العلميّة، والتّي لم تكن محلّ اهتمام في المنهج الدّراسيّ لصعوبتها وكثرة تشعّبها. وفي أحد الأيّام أتى أحد العلماء وجلس مقابل حجرته، فخرج «محمّد تقي»، فسأله العالم: هل يوجد عندك كتاب «الكتاب»[4]؟ فأجابه «محمّد تقي»: نعم! وكان العالم يظنّ أنّ هذا الطّالب لم يكن بمستوى علميّ يمكنه من فهم هذا الكتاب، فقال له: هل تبيعني إيّاه؟ فأجابه «محمّد تقي» بإحراج: نعم! فقال له العالم عندما رآه مُحرجاً: إنّ هذا الكتاب لا يفيدك! عندها بدأ «محمّد تقي» ببيان مطالب هذا الكتاب الصّعب فصلاً فصلاً أمام ذاك العالم المشهور، فَدُهش العالم وبدت آثار الاستغراب والتعجّب على وجهه، وعندما رأى العالم إحاطة هذا الطّالب بمطالب هذا الكتاب بشكل دقيق ومتقن طرح المطلب الّذي كان يريد مراجعته من الكتاب فأبانه الطّالب له وبدأ العالم يستشكل والطّالب «محمّد تقي» يجيب حتّى اجتمع عدد من الطّلبة حول تلك المباحثة بين الطّالب والعالم، وذاع صيت هذه المباحثة النّادرة من نوعها بين الأوساط. وكان العالم بعد ذلك ينصح أولاده وطلبته أن يرافقوه ويتعلّموا منه كيف يدرسون.
وينقل أيضاً أحد الفضلاء من أهل العلم وهو من أحفاد أحد كبار العلماء في كربلاء المقدسة أنّه أقبل «محمّد تقي» إلى أستاذه ليسأله عن مسألة علميّة، فأجابه الأُستاذ وذهب كي يجدّد وضوءه، وعندما انتهى أقبل إليه «محمّد تقي» وقد كتب في ورقة مضيفاً على جواب أُستاذه ثمّ أراها للأستاذ سائلاً: هل ما كتبته صحيحٌ؟ هل هذا ما كنتم تقصدونه؟ فنظر إليه هذا الأُستاذ معجباً، وبادره قائلاً: «مرحباً بتلميذٍ أفضل من الأُستاذ!».
[1] قال سماحته (قدّس سرّه) في إحدى المناسبات: «مر على إقامتي في كربلاء أكثر من سنة ثم بلغت سن التكليف».
[2] كان سماحته (قدّس سرّه) يقول: إنه قد رأى صلاة استثنائية ذات حالات معنوية خاصة غير قابلة للوصف لدى عدد محدود من الأشخاص لا يتجاوزون عدد الأصابع، حيث كان أحدهم الشّيخ أحمد السعيدي في مدينة فومن، و الآخر آية الله العظمى الميرزا النائيني (قدّس سرّهما)
[3] «اللمعة الدمشقية» كتاب فقهي للشهيد الأوّل (قدّس سرّه)، و شرحه الشهيد الثاني (قدّس سرّه) باسم «الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقية».
[4] وهو الكتاب النحوي المشهور لمؤلفه سيبويه.